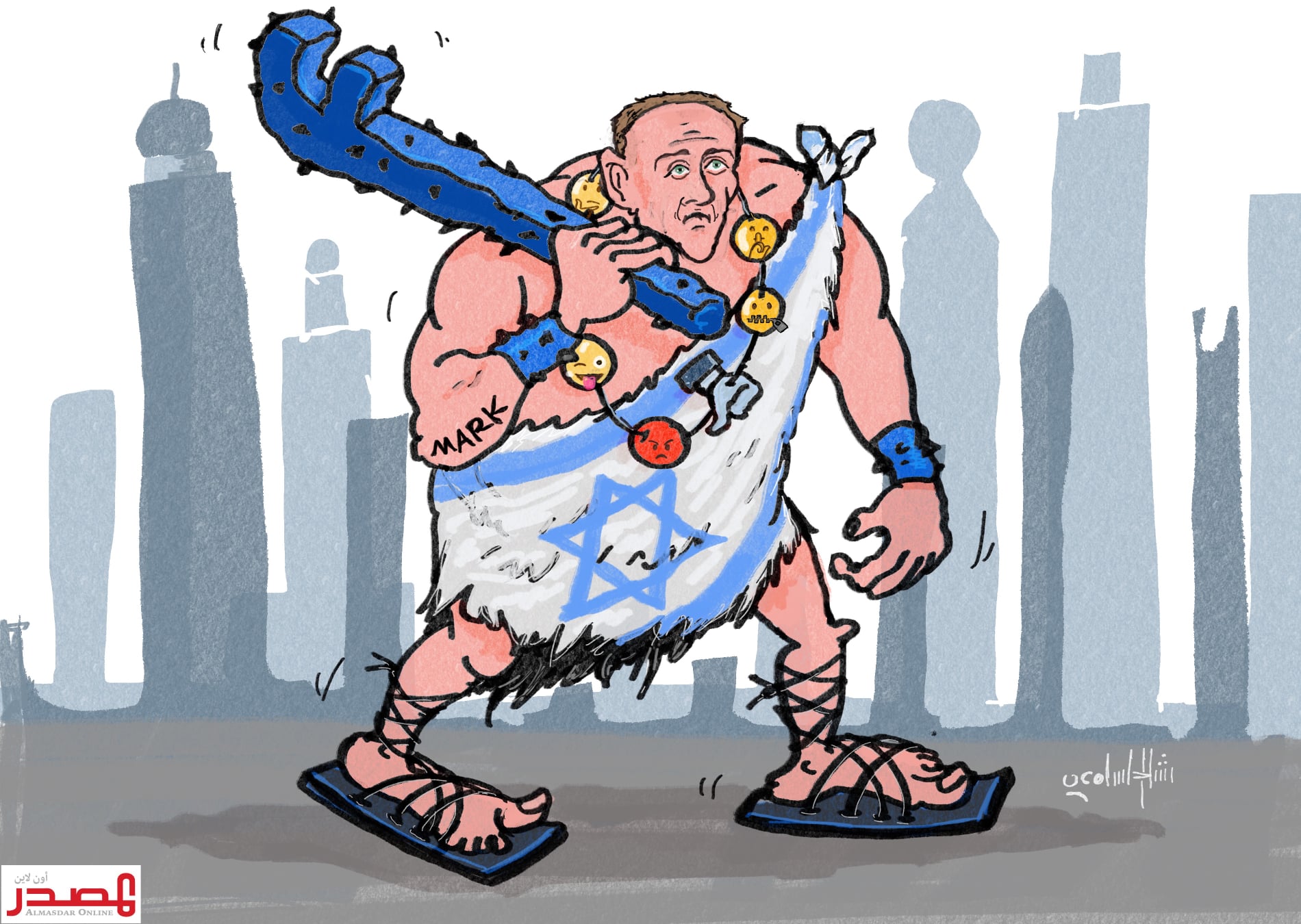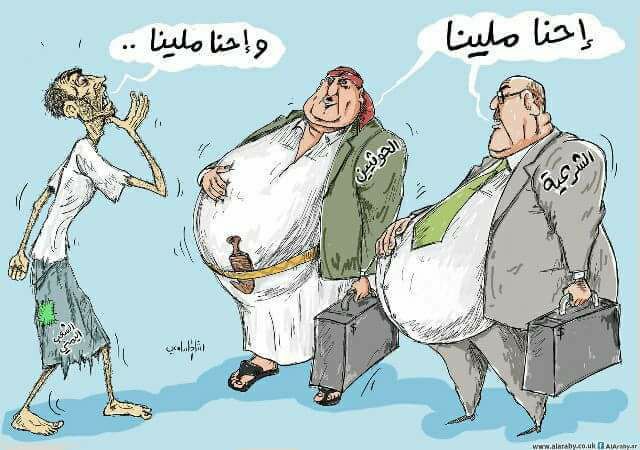هل هناك حاجة للتخلص من الإسلام؟
2017-10-12 الساعة 02:09ص
إذا افترضنا أن الإسلام هو السبب في كل ما أصاب المنطقة من خراب، خلال الفترات الماضية، وأنه يجب «تحرير شعوب المنطقة من الإسلام»، لكي تواكب ركب حضارة القرن الواحد والعشرين، حسب بعض الدعوات المرتفعة على جانبي الأطلسي، فإننا يجب أن نجيب على سؤال: كيف كان الإسلام عامل تغير إيجابي كبير لصالح المنطقة، التي شهدت بمجيئه نقلتها الحضارية الكبرى بعد القرن السابع الميلادي، الأمر الذي جعل شعوباً أخرى ترحب بالفاتحين المسلمين، في أجزاء واسعة من إفريقيا وآسيا، لدرجة اعتناقه واعتناق لغته، أو كيف يمكن افتراض أن «أداة تحرير ونهضة» شعوب المنطقة في الماضي تحولت إلى «أداة استعباد وتخلف» تلك الشعوب في الحاضر؟
ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك من يقول إن «الفتوحات الإسلامية» كانت غزواً استعمارياً إلا أن حالات شعوب مصر وشمال إفريقيا التي اعتنقت الإسلام، وتكلمت اللغة العربية تشير إلى غير ذلك، ناهيك عن الحالة الفريدة التي دخل فيها «الغازي» في دين «المغزو» كما في «الحالة المغولية» التي تحول فيها الغزاة المغول إلى الإسلام بعد غزو المشرق العربي.
ومهما يكن من أمر، فإن العامل الذي أدى إلى نتيجة معينة في ظروف معينة، يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها حال تكرار الظروف ذاتها، ولا يمكن القول إن العامل ذاته تسبب في نتيجة عكسية لأسباب تتعلف به ذاته. لا شك في أن ظروف القرن الواحد والعشرين تختلف عن ظروف وحيثيات القرن السابع، وهذا ما يعلل جانباً من الإشكالية الإسلامية المعاصرة. هذا بدوره يطرح التساؤل عن مدى صلاحية وصفة القرن السابع لـ»علَّة» القرن الحادي والعشرين، ومدى صحة العبارة حول «صحة الإسلام لكل زمان ومكان».
دعونا نطرح أن الإسلام في مجمله هو مجموعة من المجملات التي تتعالى على الظروف الزمانية والمكانية، وأن هذه المجملات لا تتغير، سواء اعتنقها أعرابي راكبُ بعير في جزيرة العرب في القرن السابع، أو رجل أعمال راكب طائرة خاصة من نيويورك في القرن الواحد والعشرين. هذه المجملات هي جزء من «المقدس الإلهي» في الإسلام، وهي «الأصول» التي يمكن أن «تصلح لكل زمان ومكان»، على عكس المفصّلات أو «الفروع» التي تشير إلى «المنتج البشري» في الإسلام من اجتهادات فقهية وغيرها، وهي التي ينبغي أن «تتكيف» تبعاً لتغير الظروف الزمكانية المحايثة.
إن الإشكالية الكبرى التي وقع فيها المسلمون منذ خروج «الموجة الحضارية» من أيديهم، تتمثل في أنهم اليوم رفعوا «المنتج البشري» في الإسلام إلى مكانة «المقدس الإلهي» فيه، الأمر الذي جعلهم يهدرون طاقاتهم الهائلة في محاولات يائسة وضد منطق التاريخ لحشر القرن الحادي والعشرين في جلباب القرن السابع، وهو ما لا يحتمه «الدين الصحيح» قدر ما يوجبه «التدين العليل» لدى كثير من المسلمين اليوم على مستوى الفكر والتصور والممارسة، حيث يتصور الكثير من المسلمين أن الإسلام «منتج صناعي»، ولكي نعيد تصنيعه في بلد آخر، فلا بد من نقل «تكنولوجيا الإنتاج» من الشركة المصنعة الأم بشكل آلي، من دون مراعاة بيئة الإنتاج الجديدة.
هذه الإشكالية في تصوري هي التي بعثت على افتراض أن الإسلام هو السبب في عدم اندماج المسلمين ضمن «المجتمع الحديث»، وبقائهم على هامش العصر، لأنه تبدى لأصحابها أن «التطبيقات الإسلامية» ما هي إلا المحاولات البائسة واليائسة لحشر عالم اليوم في جلباب عربي قديم، و»حجب المرأة المعاصرة وراء نقاب البدويات»، ولا شك لديّ في أن الأمر مختلف بشكل كبير.
هناك في هذا السياق مسألة أخرى وهي أنه لكي نفترض أن الإسلام هو السبب في تخلف المسلمين، فإننا نفترض أن المسلمين اليوم يطبقون الإسلام ويلتزمون بتعاليمه في حياتهم اليومية، الأمر الذي أدى إلى تخلفهم، ولكن قضية التزام المسلمين اليوم بتعاليم الإسلام مسألة فيها نظر على أية حال، وإذا كان الأمر كذلك فإن ربط تخلف المسلمين بالإسلام مع تقرير عدم التزامهم بتعاليمه تنم عن منطق عليل. ومسألة أخرى يجب التوقف حولها، وهي أن القائلين بربط تخلف المسلمين بالإسلام، والداعين إلى تخليص المسلمين من «هيمنته» ليس لديهم تصور واضح عن بدائل مناسبة قيمية ومفاهيمية يمكن أن تحافظ على بنية مجتمعات المنطقة وهويتها الثقافية، مع تشوش فكرة دعاة «التخليص» عن نقل «النموذج الغربي» في التفكير والحياة والتصورات إلى شعوب المنطقة.
ولكي أوضح ذلك أكثر أضرب مثلاً بسيطاً، وهو أن الدولة الغربية المعاصرة تتكفل بخدمة مواطنيها، وهناك شبكات «الضمان الاجتماعي» الضخمة، التي تكفل لكبار السن على سبيل المثال حياة مادية كريمة، بعيداً عن التزامات ذويهم وأقاربهم من الأبناء والإخوة، غير أن الحال لدى شعوب منطقتنا يختلف إلى حد ما، فمع وجود شبكات أو شبه شبكات للضمان الاجتماعي، إلا أن مسؤولية إعالة الوالدين- مثلاً تقع على الأبناء القادرين. ولذا يحول الكثير من المسلمين المغتربين في الغرب مبالغ كبيرة لأهلهم في بلدانهم الأصلية لضمان حياة معقولة لهم مدفوعين بـ»الوازع الديني» طمعاً في «رضى الله المترتب على رضى الوالدين وصلة الرحم»، وهذا تفكير غير سائد لدى المجتمعات الغربية القائمة على «الفلسفة الفردية» والتمحور حول الذات.
وهنا يبدو المطالبون بإلغاء الميراث الإسلامي لدى شعوبنا كمن يجازف بقطع تحويلات المغتربين المسلمين لذويهم في مثل هذه الظروف التاريخية الحالكة، مع عدم ضمان نقل «شبكات الضمان الاجتماعي» الغربية بشكل مناسب للبيئة العربية.
ومع تبسيطية هذا المثال وجوانب خلل فيه، إلا أنه يلقي الضوء على إشكالية الكثير من الأصوات العدمية التي ترتفع اليوم منادية بتنحية الإسلام عن المشهد لأنه هو السبب في مآسي المسلمين والعالم من ورائهم.
إن الحل الأنجع هنا من- وجهة نظر الكاتب- يتمثل في الحاجة لحركة إصلاح ديني داخلي تعيد النظر في «المنتج البشري» من الإسلام، وتعيد قراءة «المقدس الإلهي» في الدين للوصول إلى فهمنا نحن، وتفسيرنا نحن بما يتناسب وبيئتنا المكانية وظروفنا الزمانية. وعند تأمل «فلسفة التشريع» في الإسلام، ندرك أنه راعى الحساسيات الزمانية والمكانية في تشريعاته الكثيرة، وأن هذه التشريعات كانت مرنة إلى حد كبير، وما قضية «الناسخ والمنسوخ» إلا صورة واضحة لاستيعاب الإسلام لضرورة «التدرج»، وهو ما يعني حساسية شديدة تجاه الظروف الاجتماعية الملابسة.
أخيراً: نحن اليوم بحاجة إلى جهد علمي هادئ ودؤوب لإنتاج تفسيرنا الخاص الذي يمكن أن يساعد على إدماجنا في العصر، ومغادرة قرون طويلة من البقاء على هامش الدائرة. وكما كان نبي الإسلام – على سبيل المثال- يبني دينه الجديد في بيئة مكة الوثنية، وعند «البيت العتيق» الممتلئ بالأوثان والأصنام، من دون أن يلجأ إلى «هدم المعبد على من وما فيه»، فإنه بإمكان المسلمين اليوم النظر إلى تجربته الفريدة في التغيير البطيء التراكمي، الذي أنتج في نهاية المطاف تغييراً شاملاً، أدى أخيراً إلى «تحطيم الأصنام» على يد عبدتها ذاتهم، وهذه هي الثورة الحقيقية وهذا هو التغيير الأنفع.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك