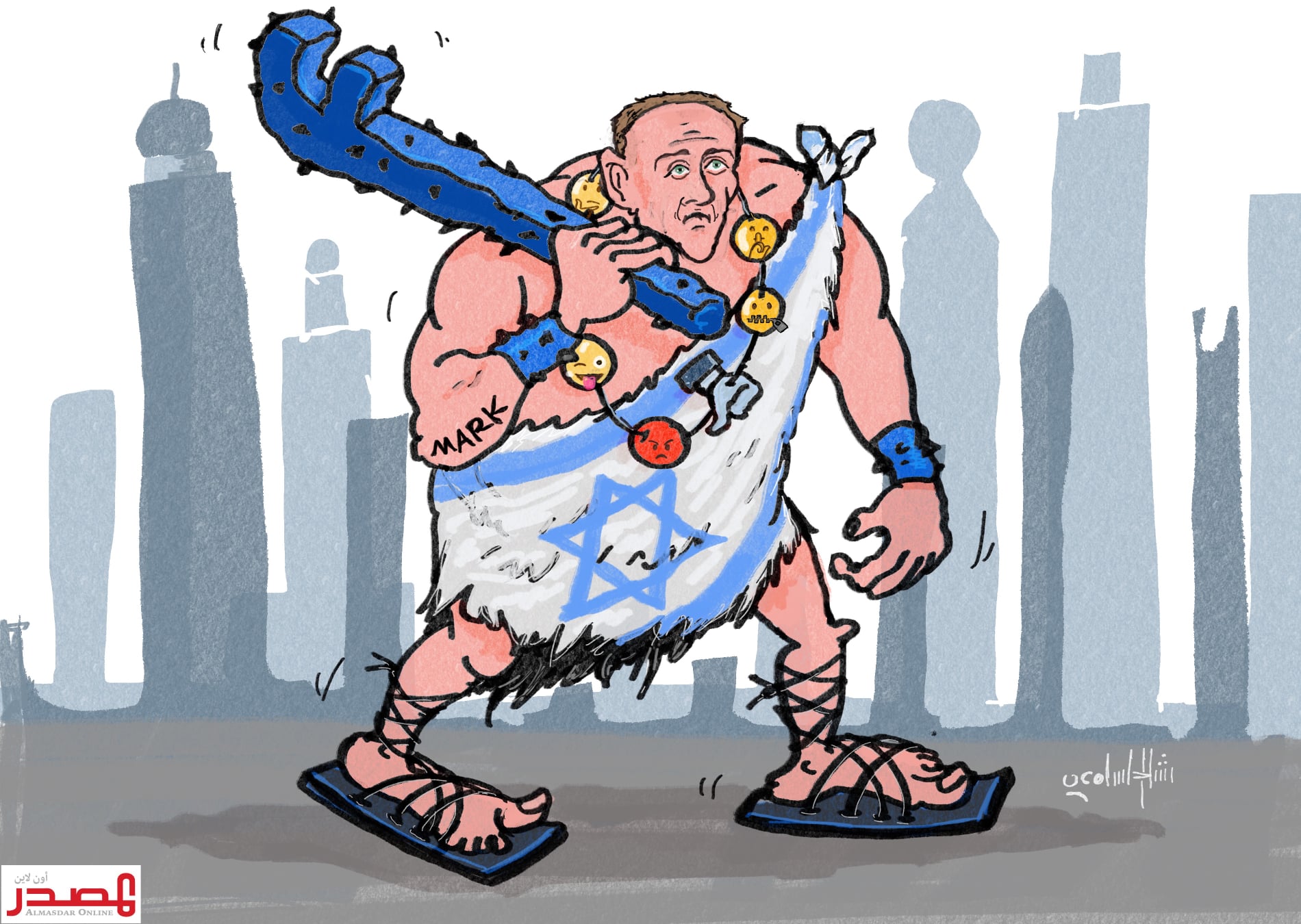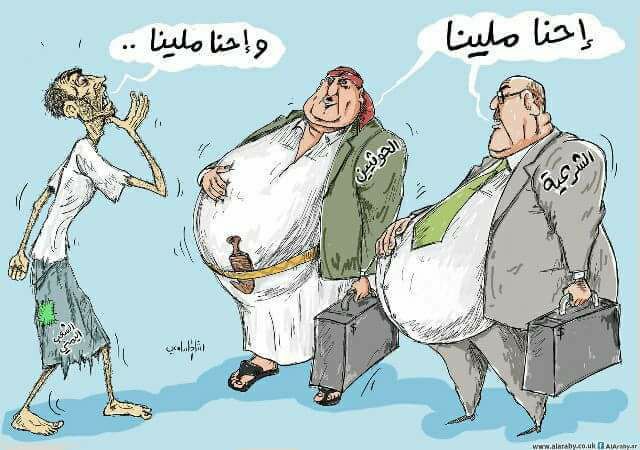مقالة عني..!
2015-12-26 الساعة 04:27م
هذه المقالة عني. لا أعرف ما إذا كان هذا مناسباً. لكنني كمواطن وكاتب عربي في هذا الزمن سريع التغيرات أستحق «مقالة عني»، فأنا أيضاً نموذج لعربي حائر، مررت وأمر بتغيرات وضغوط، وأتعرض لانتقادات وسوء فهم. صحيح أنني لست مثقفاً سورياً يعيش تجربة ذاتية معقدة، بعدما انتهى لاجئاً يعبر الحدود على قدميه عبر بلغاريا، حائراً أن يكتب خواطره الآن أو يرتاح حتى يصل إلى المحطة التالية، ولست طبيباً من الموصل عليه أن يعمل ويداوي جرحى «داعش» ويعيش في دولتهم، ومضطراً أن يسامرهم، ويناقش معهم أحوال الموصل والعراق ويسمع منهم رؤيتهم للمستقبل، فيحتار في ما إذا كان من الحكمة نصحهم أم الصبر عليهم. يتمنى لو يكتب خواطره ولكن يخشى أن تقع بين أيديهم.
لا أمر بتجربة مثيرة مثلهما، لكنني أعيش أنا الآخر تحولات لا تقل أهمية في حياتي، وإن كنت آمناً مطمئناً مستقراً، وعليّ أن أشكر حكومتي، فرغم أنها تتصدر المشهد في دفع غوائل الزمن عن بلادي وتحاول إطفاء الحرائق في ما حولها، إلا أنها لم تدخلنا في أجواء مواجهة. الحياة تمضي عادية في المملكة، بل إننا حتى نخطط لتحولات اقتصادية وتحسين أداء الحكومة والاقتصاد، وكأن لا شيء يجري حولنا، وإن كنت أعتقد بأن حكمة القيادة في السعودية أن تسرع بهذه الإصلاحات بسبب ما يجري حولنا.
حياتي تمضي طبيعية. أتابع العمل لإعادة إطلاق قناة «العرب»، أو أكتب فصلاً آخر من كتابي الجديد، وأطمئن على أبنائي وبناتي المنتشرين بين ثلاث مدن، وفي نهاية اليوم أشاهد فيلماً مع زوجتي أو أناقش معها رجيم «قليل الكربوهيدرات» الذي أتبعه الآن، ولا يقطع برنامجي الهادئ هذا غير سفرات عمل.
لكن ثمة ما أستحق أن أرويه، فأنا أيضاً تأثرت بـ «الربيع العربي». ينتقدني بعضهم كلما قلت إنه «حتمية تاريخية»، وكأنني لو هاجمت الربيع وسميته الخريف أو الكابوس أو حتى المؤامرة، فسنستطيع بأحكامنا هذه أن نوقفه، لذلك أفضل أن أصفه كما هو «حتمية تاريخية»، حتى أكون أميناً ونستطيع التعامل معه.
لكن مشكلتي بدأت تحديداً بعدما حصل ما حصل في مصر في صيف العام 2013، فمنذ ذلك اليوم وأنا أخسر أصدقاء. لم اسمه انقلاباً كما سماه زميلي الكاتب في هذه الصحيفة الدكتور خالد الدخيل، فهو أستاذ علوم سياسة متخصص وبالتالي دقيق في توصيفه. سمّيته استعادة العسكر لسلطة في حوزتهم منذ ألف سنة، ووصفتهم في مقالاتي هنا غير مرة بأنهم استمرار لسلطة المماليك، أكثر منهم استمراراً لثورة العام 1952. انقلاب لا يريدونه أن يكون انقلاباً، فأجروا بعده انتخابات انبثق عنها برلمان. حتى عبدالناصر لم يرد انقلاب العام 1952 أن يكون انقلاباً فسماه ثورة، فكلمة انقلاب غير مستحبة في بلد قدم أول دستور ونظام برلماني في العالم العربي.
ربما لم يكونوا أصدقاء، فالصديق الحقيقي لا تخسره عندما تختلف معه في الرأي. غضبوا عليّ أكثر من غيري ممن لم يتحمس لمشروع «30 يونيو»، مثل الدكتور الدخيل سالف الذكر والدكتور فهد العرابي الحارثي عضو الشورى سابقاً ورئيس مركز بحثي حالياً. بعضهم يزعم أنني خدعته، إذ بدوت بمظهر الليبرالي، ولكن تبين أنني ليبرالي مزيف إذ لم أرحب مثلهم بـ «الثورة الشعبية» التي أسقطت «الإخوان الرجعيين وتجار الدين»، كما يختصرون الصورة المعقدة التي جرت في ذلك الصيف.
لم أستطع أن أقنعهم بأن موقفي مبادئي، التزام بالحرية والديموقراطية، لقناعتي بأنها الحل الأفضل للجمهوريات العربية التي فشلت وتدهورت أحوالها بسبب حكم العسكر، والحق أنني تحمست لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 في مصر، ذلك أنني اعتقدت أن دورة الحرية والديموقراطية أصابتنا أخيراً نحن العرب في موجتها الخامسة، بعدما مرت على اليونان وإسبانيا، ثم أميركا اللاتينية، ثم شرق آسيا، وأخيراً تركيا وأوروبا الشرقية. أعترف بأنني مؤمن بأنها التطور الطبيعي للإنسان المتحضر، وعزز قناعتي هذه كتاب فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ»، لكنهم أصروا على أن موقفي هذا لأنني «إخوانجي» مستتر. لم تشفع لي مقالاتي الكثيرة التي انتقدت فيها «الإخوان» وحملت فيها قياداتهم مسؤولية انهيار الديموقراطية، لكنني لم أستطع أن أكتب مقالة واحدة أبرر فيها عودة العسكر إلى السلطة لأنني مؤمن بأنهم لا يجيدونها.
بدأت قصتي مبكرة مع زميل شاب، أضحى رئيساً لتحرير صحيفة مهمة، أنكر عليّ أن احتفيت بصورة الشيخ يوسف القرضاوي يلقي خطبة الجمعة في ميدان التحرير، بعد أسبوع من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. بهرتني رمزية اللحظة، إذ رأيتها دلالة على إطلاق حرية التعبير في مصر، لكنه لم يستطع أن يرى غير «الإخوان المسلمين» في الصورة، فكتب مقالة عنوانها «المخادعون»، قال فيها إنني خدعته وغيره عندما عرفوني كرئيس تحرير «ليبرالي»، مستعد أن يخاصم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال إدارتي لصحيفة «الوطن» ذائعة الصيت. فهمه البسيط جعله يخلط بين «الإخوان» والهيئة، ولا يستوعب أن الليبرالية هي للجميع، وأنها إن أضحت انتقائية لن تكون ليبرالية.
ذاك الذي كان صديقي، يعيش كآخرين في «قالب» فيريدني في القالب نفسه كي يرضى عني. لكن صاحب القلم الحر لا يعيش في القوالب، فهو لا يتتبعها، وإنما هو خلف المبدأ، فتجده في كل القوالب بل لا يعترف بها، ومع كل التيارات طالما أنها مع مبدئه في الحرية والحقوق.
كتبت أيضاً خلال الفترة نفسها مقالات أدعو فيها إلى ضرورة أن تحتوي الدول العربية المستقرة أخواتها المضطربة، ودعوت إلى خطة مارشال عربية، ولا حاجة إلى شرحها، فالفكرة تم تداولها حتى ضاع وهجها، فرد عليّ زميل آخر بمقالة مطولة في الصحيفة ذاتها: «تريد خطة مارشال لدعم الإخوان المسلمين». منطق كهذا لا يمكن مناقشته، وأكتفي بتسجيله خصوصاً، عندما أجد الزميل يحتفي لاحقاً بدعم حكم غير شفاف، فيصفه بالموقف الشجاع والنبيل. نعم، إنها أهواؤنا تحكم آراءنا. بعضنا هواه حر، وبعضنا غير ذلك.
قبل أسابيع قليلة كنت مع الصديق والأستاذ في جامعة هارفرد نواف عبيد في لندن. عتب عليّ قائلاً: «يجب أن تكتب مقالة تؤكد فيها أنك لست إخوانجياً»، قلت له: «مهما قلت لن يقتنع من أصيب بالإخوانوفوبيا، فهو يقول ذلك لأنني أنتقد نظامه المفضل. جرب أن تفعل ذلك وستتهم بأنك إخوانجي». فعل نواف ذلك ببضع تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، فاتهم فوراً بأنه عضو فعّال في «الإخوان»، وأضحى ذلك محل تندر بيننا، فآخر واحد يمكن أن يلتحق بـ «الإخوان» سيكون الدكتور عبيد.
حافظت على مواقفي، ويبدو أن هناك من أصر على أن آرائي الخارجة عن الصندوق المعتاد، لا بد من أن تكون معبرة عن رأي الحكومة، ففي عالمنا العربي يتعامل الجميع على أن الصحافيين مجرد أقلام قابلة للضغط أو الكسر متى لزم الأمر، ولا يمكن أن يكونوا مستقلين، فصدر بيان رسمي يقرر المقرر، أنني أمثل نفسي، وهو الشيء الصحيح، ولكن لم يطلب مني أحد أن أغير رأياً هنا أو هناك، فما قيمتي لو حصل ذلك؟
تعجبني أجواء الحرية، ويجب أن نحافظ عليها، وسعيد بأن حكومة بلادي تفعل ذلك. في ليلة صدور البيان، التقيت في ديوانية عامة في الرياض مع مجموعة من الشباب، دعوني قبلها بأيام إلى الحديث معهم حول تقلبات الأوضاع في عالمنا. حرصت أكثر ليلتها على لقائهم، وسعدت أكثر بأن اللقاء مسجل ويبث على الشبكة من دون أي اجتزاء. كان ذلك أفضل علاج نفسي احتجته بعد البيان، ومقالات تهاجمني، وأصدقاء يهجرونني. تحدثت مع الشباب لساعتين وأكثر، وأجبت عن أسئلتهم بكل حرية ومن دون قيود، وشعرت بأن الدنيا لا يمكن أن تضيق على إنسان حر في داخله.
أريد أن أمارس الحرية، وأفكر بحرية وأكتب بحرية، قد أخطئ وأشرق وأغرب، ولكن من الحرية أن أخطئ وأشرق وأغرب، فكيف نهتدي إلى الطريق الصحيح إن لم نفعل؟ أخيراً حمدت الله أنني كاتب في الرياض، ولست ذلك الطبيب الذي تركته في بداية المقالة في الموصل.